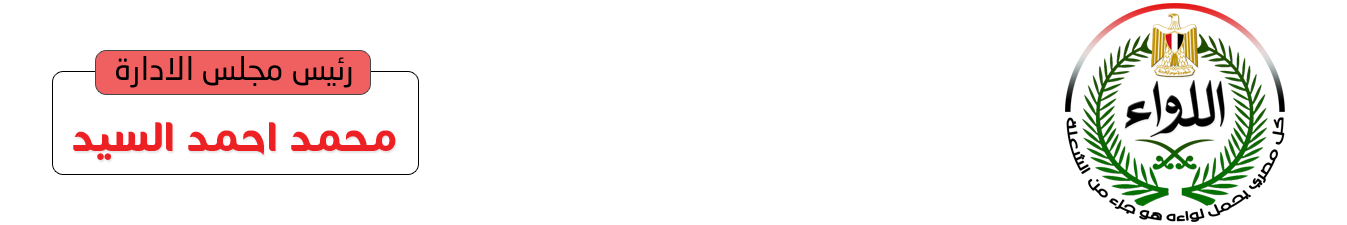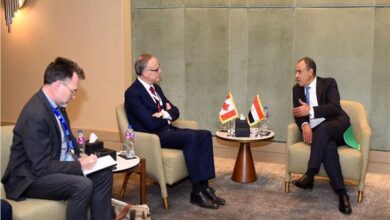6أكتوبر 1973.. يوم العبور العظيم واحد وخمسون عام على تحطيم خط بارليف نبراس تقتدى به الاجيال القادمة
موجات عبور واقتحام أكبر مانع مائى لقناة السويس وتحطيم خط بارليف صفحة ناصعة فى تاريخ العسكرية المصرية ..من أرشيف الجبهة فيلم " القرار"

6أكتوبر 1973.. يوم العبور العظيم واحد وخمسون عام على تحطيم خط بارليف نبراس تقتدى به الاجيال القادمة

كتبت : منا احمد
اتخذ النصر في 6 أكتوبر 1973 مسميات كثيرة على لسان المصريين ولكن ظل “يوم العبورالعظيم ” واحدا من أهمها معنى ومبنى، وصفا وتجسيدا، ودقة واتساعا وشمولا.. وبات من الواضح أن معنى “العبور” فتح للمصريين قوس التوقعات وقدم احتمالات كثيرة، وأماني بأن ينسحب ذلك العبور على كل المشكلات والأزمات التي تحيط بنا ونعيشها ونهدف إلى تجاوزها، وأن نستلهمها في كل المجالات والتطلعات.
– الضربة الجوية
في تمام الساعة 1400 من يوم 6 أكتوبر 1973 نفذت 220 طائرة حربية مصرية ضربة جوية على الأهداف الإسرائيلية شرقي القناة (كان أقصى عمق ممكن للطائرات المصرية خط المضائق في منتصف سيناء، وعليه غطت الضربة الجوية النصف الغربي من سيناء عدا هجوم واحد قصف مطارا جنوب العريش
عبرت الطائرات على ارتفاعات منخفضة للغاية (حوالي 30 م) لتفادي الرادارات الإسرائيلية، وقد استهدفت المطارات ومراكز القيادة ومحطات الرادار والإعاقة الإلكترونية وبطاريات الدفاع الجوي وتجمعات الأفراد والمدرعات والدبابات والمدفعية والنقاط الحصينة في خط بارليف ومصافي النفط ومخازن الذخيرة.

جاء في تقرير قائد القوى الجوية عقب الهجوم أن الضربة حققت 95 % من أهدافها الموضوعة، وخسرت أحد عشر طيارا شهيدا منهم ستة طيارين في الغارة على مطار الطور قرب شرم الشيخ ويعود ذلك لفقدان عنصر المفاجأة بسبب ملاقاتهم أربع طائرات فانتوم كانت تقوم بدورية اعتيادية فوق شرم الشيخ فجرت معركة غير متكافئة بسبب التفوق النوعي لطائرة الفانتوم وقتئذ
التمهيد المدفعي
بعد عبور الطائرات المصرية بخمس دقائق بدأت المدفعية المصرية قصف التحصينات والأهداف الإسرائيلية الواقعة شرق القناة بشكل مكثف تحضيرا لعبور المشاة، فيما تسللت عناصر سلاح المهندسين والصاعقة إلى الشاطئ الشرقي للقناة لإغلاق الأنابيب التي تنقل السائل المشتعل إلى سطح المياه وفي تمام الساعة 14:20 توقفت المدفعية ذات خط المرور العالي عن قصف النسق الأمامي لخط بارليف ونقلت نيرانها إلى العمق حيث مواقع النسق الثاني، وقامت المدفعية ذات خط المرور المسطح بالضرب المباشر على مواقع خط بارليف لتأمين عبور المشاة من نيرانها.
العبور
في تمام الساعة 18:30 كان ألفا ضابط وثلاثين ألف جندي من خمس فرق مشاة قد عبروا القناة، واحتفظوا بخمسة رؤوس جسور واستمر سلاح المهندسين في فتح الثغرات في الساتر الترابي لإتمام مرور الدبابات والمركبات البرية، وذلك فيما عدا لواء برمائي مكون من عشرين دبابة برمائية وثمانين مركبة برمائية عبر البحيرات المرة في قطاع الجيش الثالث وبدأ يتعامل مع القوات الإسرائيلية.
في تمام الساعة 20:30 اكتمل بناء أول جسر ثقيل، وفي تمام الساعة 22:30 اكتمل بناء سبع جسور أخرى وبدأت الدبابات والأسلحة الثقيلة تتدفق نحو الشرق مستخدمةً الجسور السبع وإحدى وثلاثين معدية.
عقب بدء الهجوم حققت القوات المسلحة المصرية والسورية أهدافها من شن الحرب على إسرائيل، وكانت هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى للمعارك، فعبرت القوات المصرية قناة السويس بنجاح وحطمت حصون خط بارليف وتوغلت 20 كم شرقا داخل سيناء، فيما تمكنت القوات السورية من التوغل إلى عمق هضبة الجولان وصولا إلى سهل الحولة وبحيرة طبريا.
أما في نهاية الحرب فقد تمكن الجيش الإسرائيلي من تحقيق بعض الإنجازات، فعلى الجبهة المصرية تمكن من فتح ثغرة الدفرسوار وعبر للضفة الغربية للقناة وضرب الحصار على الجيش الثالث الميداني ومدينة السويس ولكنه فشل في تحقيق أي مكاسب استراتيجية سواء باحتلال مدينتي الإسماعيلية أو السويس أو تدمير الجيش الثالث أو إجبار القوات المصرية على الانسحاب إلى الضفة الغربية مرة أخرى، أما على الجبهة السورية فتمكن من رد القوات السورية عن هضبة الجولان واحتلالها مرة أخرى.

وتدخلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لتعويض خسائر الأطراف المتحاربة، فمدت الولايات المتحدة جسرا جويا لإسرائيل بلغ إجمالي ما نقل عبره 27895 طنا، في حين مد الاتحاد السوفيتي جسرا جويا لكل من مصر وسوريا بلغ إجمالي ما نقل عبره 15000 طن إضافة إلى نحو 63,000 طن من الأسلحة عن طريق البحر وصلت قبل وقف إطلاق النار، نقل أكثرها إلى سوريا.
وانتهت الحرب رسميا مع نهاية يوم 24 أكتوبر من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي والإسرائيلي، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ على الجبهة المصرية فعليا حتى 28 أكتوبر.
على الجبهة المصرية حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية، وعلى الرغم من حصار الجيش المصري الثالث شرق القناة، فقد وقفت القوات الإسرائيلية كذلك عاجزة عن السيطرة على مدينتي السويس والإسماعيلية غرب القناة.
تلا ذلك مباحثات الكيلو 101 واتفاقيتي فض اشتباك، ثم جرى لاحقا بعد سنوات توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979، واسترداد مصر لسيادتها الكاملة على سيناء وقناة السويس في 25 أبريل 1982، ما عدا طابا التي تم تحريرها عن طريق التحكيم الدولي في 19 مارس 1989
أما على الجبهة السورية، فقد وسع الجيش الإسرائيلي الأراضي التي يحتلها وتمدد حوالي 500 كم2 وراء حدود عام 1967 فيما عرف باسم جيب سعسع، وتلا ذلك حصول حرب استنزاف بين الجانبين السوري والإسرائيلي استمرت 82 يوما في العام التالي، وانتهت باتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل والتي نصت على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها في حرب أكتوبر، ومن مدينة القنيطرة، بالإضافة لإقامة حزام أمني منزوع السلاح على طول خط الحدود الفاصل بين الجانب السوري والأراضي التي تحتلها إسرائيل
مقدمات الحرب
في 28 سبتمبر 1970 توفي الرئيس جمال عبد الناصر، وانتخب نائبه أنور السادات رئيسا لمصر في 15 أكتوبر 1970 عقد السادات النية على دخول الحرب وأعلن ذلك في عدة مناسبات منها إعلانه في 22 يونيو 1971 أن عام 1971 هو عام الحسم، وكلامه أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 24 أكتوبر 1972 الذي أوضح فيه وجوب تجهيز القوات المسلحة لدخول الحرب.
في عام 1973 قرر الرئيسان المصري أنور السادات والسوري حافظ الأسد اللجوء إلى الحرب لاسترداد الأرض التي خسرتها الدولتان في حرب 1967، فقرر مجلس اتحاد الجمهوريات العربية في 10 يناير 1973 تعيين الفريق أول أحمد إسماعيل علي قائدا عاما للقوات الاتحادية، وخلال يومي 22 و23 أغسطس 1973 اجتمع القادة العسكريون السوريون برئاسة مصطفى طلاس وزير الدفاع مع القادة العسكريين المصريين برئاسة أحمد إسماعيل علي في الإسكندرية سرا ليشكلوا معا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والسورية المكون من 13 قائد، وذلك للبت في الموضوعات العسكرية المشتركة والاتفاق النهائي على موعد الحرب، واتفق في هذا الاجتماع على بدء الحرب في أكتوبر 1973، وخلال اجتماع السادات مع الأسد في دمشق يومي 28 و29 أغسطس اتفقا على أن يكون يوم 6 أكتوبر 1973 هو يوم بدء الحرب.
التخطيط
حينما تولى السادات منصب الرئاسة عام 1970 لم تكن القيادة العسكرية المصرية تمتلك خططا عسكريةً لمهاجمة القوات الإسرائيلية، والتي تحتل شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة منذ حرب 1967 وكل ما كانت تمتلكه هو خطة دفاعية أطلق عليها اسم “الخطة 200″، بجانب خطة تعرضية تسمى “جرانيت” والتي تشمل تنفيذ بعض الغارات على مواقع القوات الإسرائيلية في سيناء إلا أنها لم تكن بالمستوى الذي يسمح بتسميتها خطةً هجومية
بدأ الإعداد للخطط الهجومية المصرية عقب تولي الفريق سعد الشاذلي منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة في 16 مايو 1971 والذي بدأ مهام عمله بدراسة الإمكانيات الفعلية للقوات المسلحة المصرية ومقارنتها بالمعلومات المتاحة عن قدرات الجيش الإسرائيلي وذلك بهدف التوصل إلى خطةٍ هجومية واقعية تتوافق مع الإمكانيات المتاحة للقوات المصرية في ذلك الوقت
وخلص الشاذلي من دراسته -وطبقا للإمكانيات المتاحة- بأن المعركة يجب أن تكون محدودة وأن يكون هدفها عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف ثم اتخاذ أوضاعٍ دفاعية على مسافة تتراوح ما بين 10 و12 كم شرق القناة، وأن تبقى القوات في تلك الأوضاع الجديدة إلى أن يتم تجهيزها وتدريبها للقيام بالمرحلة التالية من تحرير الأرض
عرض الشاذلي فكرته على وزير الحربية الفريق الأول محمد صادق، إلا أنه عارضها بحجة أنها ستبقي ما يزيد عن 60,000 كم² من أراضي سيناء بالإضافة إلى قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن أنها ستوجد وضعا عسكريا أصعب من وضع الجبهة الحالي الذي يحتمي خلف قناة السويس باعتبارها مانعا مائيا جيدا، وكان يرغب في التخطيط لعملية عسكرية هجومية تهدف إلى تدمير جميع القوات الإسرائيلية في سيناء لتحريرها هي وقطاع غزة في عملية واحدة ومستمرة
في نهاية المطاف وبعد نقاشات وجلسات مطولة جرى التوصل إلى حل وسط تمثل في إعداد خطتين الأولى هي “العملية/الخطة 41” التي تهدف إلى الاستيلاء على المضائق الجبلية في سيناء وقد أُعدت بالتعاون مع المستشارين السوڤييت بهدف إطلاعهم على احتياجات القوات المسلحة لتنفيذ الخطة، والثانية هي “خطة المآذن العالية” وتهدف إلى عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واحتلاله واتخاذ أوضاعٍ دفاعية واستنزاف إمكانيات الجيش الإسرائيلي إلى حين القيام بالمرحلة التالية من المعركة، وجرى إعداد تلك الخطة في سرية تامة بعيدا عن أعين المستشارين السوڤييت
وخلال عام 1972 أدخلت تعديلات على “العملية/الخطة 41” وتغير اسمها إلى “جرانيت 2” ولكن بقي جوهرها كما هو وركزت القوات المسلحة المصرية على تنفيذ “خطة المآذن العالية” التي كانت تناسب إمكاناتها في ذلك الوقت، وتغير اسم الخطة في سبتمبر 1973 إلى “الخطة بدر” بعد أن تحدد موعد الهجوم ليكون السادس من أكتوبر من العام نفسه وبناء على هذه الخطة صدر “التوجيه 41” عن رئاسة الأركان المصرية الذي نظم عملية العبور
– اختيار موعد الحرب
في 22 يوليو 1972 طلب الرئيس السادات سحب المستشارين العسكريين السوڤييت من مصر، وقرر أن الحرب ستجري بما هو متوفر من السلاح والمعدات وضمن طاقتها التي تسمح بها. منذ تكليف السادات للقوات المسلحة بالاستعداد للحرب في مؤتمر الجيزة يوم 24 أكتوبر 1972 عملت هيئة عمليات القوات المسلحة برئاسة اللواء عبد الغني الجمسي على تحديد أنسب التوقيتات للهجوم، وذلك بناء على عدة عوامل منها الموقف العسكري الإسرائيلي، وحالة القوات المصرية، والمواصفات الفنية للقناة من ناحية حالة المد والجزر وسرعة التيار واتجاهه والأحوال الجوية، وذلك بهدف تحقيق أفضل الظروف للقوات المصرية وأسوأها للقوات الإسرائيلية، مع مراعاة أن يناسب التاريخ الجبهة السورية أيضا (يبدأ الثلج والجليد في نوفمبر على مرتفعات الجولان فتوجب ألا تتأخر الحرب عن أكتوبر).
بناء على العديد من الدراسات حددت شهور مايو أو أغسطس أو سبتمبر-أكتوبر كأنسب الشهور للهجوم، وكان أفضلها شهر أكتوبر 1973 لعدة أسباب منها لكونه أفضل الشهورِ بالنسبة لحالة المناخ على كلا الجبهتين المصرية والسورية، كما أن الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية ستجرى يوم 28 منه وسينشغل الشعب والجيش بالحملات الانتخابية (باعتبار جميع المدنيين القادرين على حمل السلاح هم عناصر احتياط في الجيش في إسرائيل)، وبعد دراسة العطلات الرسمية في إسرائيل حيث تكون قواتها المسلحة في أدنى استعداداتها وجد أن يوم السبت -عيد الغفران أو كيبور- 6 أكتوبر 1973 م / 10 رمضان 1393 هـ هو الأنسب لأنه اليوم الوحيد في السنة الذي تتوقف فيه الإذاعة والتلفزة عن البث، مما سيتطلب من إسرائيل وقتا أطول لاستدعاء الاحتياطي الذي يمثل القاعدة العريضة لقواتها المسلحة.
واختيرت الساعة 14:00 (1400 وفق العرف العسكري) بعد الظهر لانطلاق الهجوم حيث تكون الشمس جهة الغرب خلف ظهور المصريين وتغشى عيون الإسرائيليين مما يتيح رؤيةً جيدة جدا للمهاجمين على عكس المدافعين، وتقرر هذا في الاجتماع المشترك السري بين القيادتين العسكريتين المصرية والسورية برئاسة وزيري الدفاع في 22 أغسطس في قيادة القوات البحرية في الإسكندرية.
نصر أكتوبر .. بداية طريق السلام
على مدار واحد وخمسون عام يحتفل الشعب المصرى وجيشه العظيم بنصر أكتوبر 1973 حقق أروع الإنجازات العسكرية المصرية .. قضى على أسطورة إسرائيل التي لا تقهر .. وبتر ذراعها الطويلة التي ظلت تتباهى بها سنوات ما بعد الهزيمة .. وفتح الطريق نحو السلام الحقيقي الذي سعت إليه مصر .. وهي في قمة انتصاراتها
قبل انتصار أكتوبر كان هناك طرف رابح وطرف خاسر .. ولم يكن ممكنا لمثل هذه المعادلة المختلة أن تقيم سلاما متوازنا، لذلك .. كان خيار السلاح حتميا لضبط هذه المعادلة أن السلام يستند إلى العدل والمنطق واحترام حقوق كل الأطراف .. وليس إلى القوة الغاشمة واحتلال أراضي الغير
التحرك نحو الحل الشامل تم من خلال استراتيجية “الخطوة الخطوة” والى بدأت بخطوة اتفاق النقاط الست فى نوفمبر 73 ثم اتفاق فض الاشتباك الأول فى يناير 1974، أعقبه اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل فى يونيه 1974، وأخيراً اتفاق فض الاشتباك الثانى مع مصر فى سبتمبر 1975.. وصولا إلى مبادرة السلام المصرية عام 1977 بزيارة الرئيس السادات للقدس والتى مثلت بداية مرحلة جديدة مختلفة تماما فى مسيرة السلام بالانتقال إلى التسوية الشاملة وأدت المبادرة على توقيع إطار السلام فى كامب ديفيد ثم معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فى واشنطن فى مارس 1979 .
-4 سنوات مفاوضات غير مثمرة
بعد أربع سنوات من النتائج غير المثمرة للمفاوضات غير المباشرة بين أطراف حرب أكتوبر بوساطة أمريكية، أعلن السادات في 9 نوفمبر 1977 من داخل البرلمان المصري استعداده للذهاب إلى الكنيست الإسرائيلي من أجل دفع عملية السلام بين مصر وإسرائيل، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل العالم العربي في ذلك الوقت
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن ورئيس الولايات المتحدة جيمي كارتر بإعلان السادات، وعلق عليها الرئيس الأمريكي بأن “السادات يشبه أول رجل صعد إلى سطح القمر”
وتحدد لزيارته يوم السبت الموافق 19 نوفمبر 1977. قام السادات أيضا قبل زيارته إسرائيل بزيارة سوريا لتنسيق المواقف، فأعلن الجانب السوري اعتراضه على تلك الزيارة إلا أن السادات قرر المضي قدما بخطوة التفاوض المباشر، وأعلن من داخل الكنيست الإسرائيلي أنه لم يجئ ليعقد اتفاقا منفردا بين مصر وإسرائيل وأن الانسحاب الكامل من الأرض العربية المحتلة عام 1967 أمر بديهي لا يقبل فيه الجدل ولا رجاء فيه لأحد أو من أحد، وأنه لا معنى للحديث عن السلام مع استمرار احتلال الأرض العربية
ودعا السادات بيجن لزيارة مصر، وعقد مؤتمر قمة في الإسماعيلية في 25 ديسمبر 1977 بين الطرفين

– اتفاقية كامب ديفيد
عقد مؤتمر كامب ديفيد خلال الفترة من 4 إلى 17 سبتمبر 1978 بهدف الوصول إلى حلول نهائية للقضايا العالقة بين كل من مصر وإسرائيل. ترأس الوفد المصري أنور السادات “الرئيس المصري”
وبعضوية كل من حسن التهامي “نائب رئيس الوزراء”، محمد إبراهيم كامل “وزير الخارجية”، بطرس غالي “وزير الدولة للشؤون الخارجية”، أسامة الباز، نبيل العربي “المستشار القانوني لوزارة الخارجية”، عبد الرؤوف الريدي، أحمد ماهر، أحمد أبو الغيط
وترأس الوفد الإسرائيلي مناحم بيجن “رئيس الوزراء” وبعضوية كل من موشيه ديان “وزير الخارجية”، عيزرا وايزمان “وزير الدفاع”، أهارون باراك “المستشار القانوني” فيما قاد الوساطة الوفد الأمريكي برئاسة جيمي كارتر “الرئيس الأمريكي” وبعضوية كل من زبجنيو بريجينسكي “مستشار الأمن القومي”، سايرس فانس “وزير الخارجية”، وليام كوانت
في نهاية المفاوضات وقع الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي على اتفاقية كامب ديفيد في مساء يوم 17 سبتمبر 1978 داخل البيت الأبيض، والتي نصت على الانسحاب الإسرائيلي الشامل وممارسة مصر سيادتها كاملة على سيناء، حرية ملاحة السفن الإسرائيلية في المضايق وخليج السويس وقناة السويس، الاستخدام المدني للمطارات التي شيدتها إسرائيل في سيناء.
أدى توقيع الاتفاقية إلى غضب عارم في العالم العربي نتج عنه تجميد عضوية مصر في جامعة الدول العربية ونقل مقر الجامعة إلى تونس بدلا من القاهرة خلال الفترة من عام 1979 إلى عام 1989 وفي 10 ديسمبر 1978 منح السادات وبيجن جائزة نوبل للسلام مناصفة احتفاء بتوقيع الاتفاقية

– معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل
في 26 مارس 1979 وقع الرئيس السادات ورئيس الوزراء مناحم بيجن على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في البيت الأبيض بواشنطن، والتي نصت على :
إنهاء حالة الحرب بين الطرفين وإقامة سلام عادل بينهما
سحب إسرائيل لكافة قواتها العسكرية وأفرادها المدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين
استئناف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء
إقامة الطرفين علاقات طبيعية وودية بما في ذلك الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة
التعهد بالامتناع عن تهديد الآخر باستخدام القوة وحل كافة المنازعات بالوسائل السلمية
تعهد كل طرف بعدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية
إقامة ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين دوليين وتعدل الترتيبات الأمنية باتفاق الطرفين بناء على طلب أحدهما
كفالة حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية في قناة السويس وخليج السويس وخليج العقبة والمضايق والبحر الأبيض المتوسط شأنها شأن جميع الدول
حل الخلافات الناشئة حول تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق التفاوض وإذا لم يتيسر حلها بتلك الطريقة تحال إلى التحكيم
وفي 9 أبريل 1979 أقر مجلس الشعب المصري المعاهدة بالأغلبية
في أعقاب توقيع اتفاقية المعاهدة، أعلن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر تقديم اتفاق اقتصادي وأخرعسكري سنويا لكل من مصر وإسرائيل مقابل الحفاظ على السلام في المنطقة وتحول تلك الاتفاق منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار اتفاق اقتصادي، و1.3 مليار دولاراتفاق عسكرية.
– تحرير سيناء
أدت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من سيناء، وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها طبقا لجدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء على النحو التالي :
في 26 مايو 1979 رفع العلم المصري على مدينة العريش وانسحبت إسرائيل من خط العريش/رأس محمد. * في 26 يوليو 1979 انسحبت إسرائيل من مساحة 6 آلاف كم من أبوزنيبة حتى أبو خربة
في 19 نوفمبر 1979 تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية
في 19 نوفمبر 1979 انسحبت إسرائيل من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبر ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.
في 25 أبريل 1982 خلال عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، وأُعلن هذا اليوم عيدا قوميا مصريا في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير ممثلا في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، والتي تم تحريرها في النهاية عن طريق التحكيم الدولي.

– تحرير طابا
بعد عقد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979، والتي بموجبها بدأت إسرائيل انسحابها من سيناء، وفي أواخر عام 1981 الذي كان يتم خلاله تنفيذ المرحلة الأخيرة من مراحل هذا الانسحاب، سعى الجانب الإسرائيلي إلى افتعال أزمة تعرقل هذه المرحلة، وتمثل ذلك بإثارة مشكلات حول وضع 14 علامة حدودية أهمها العلامة (91) في طابا، الأمر الذي أدى لإبرام اتفاق في 25 أبريل 1982 والخاص بالإجراء المؤقت لحل مسائل الحدود، والذي نص على عدم إقامة إسرائيل لأي إنشاءات وحظر ممارسة مظاهر السيادة، وأن الفصل النهائي في مسائل وضع علامات الحدود المختلف عليها يجب أن يتم وفقا لأحكام المادة السابعة من معاهدة السلام المبرمة بين البلدين، والتي تنص على حل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات، وأنه إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات بالمفاوضات فتحل عن طريق التوفيق أو تحال إلى التحكيم
وبعد 3 أشهر من هذا الاتفاق افتتحت إسرائيل فندق وقرية سياحية وأدخلت قوات حرس الحدود فقامت الحكومة المصرية بالرد عن طريق تشكيل اللجنة القومية للدفاع عن طابا أو اللجنة القومية العليا لطابا، وتشكلت بالخارجية المصرية لجنة لإعداد مشارطة التحكيم برئاسة نبيل العربي ممثل الحكومة المصرية أمام هيئة التحكيم في جنيف
عقب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالموافقة على التحكيم، تم توقيع اتفاقية المشارطة بمشاركة شمعون بيريز في 11 سبتمبر 1986، والتي قبلتها إسرائيل بضغط من الولايات المتحدة.
وهدفت مصر من تلك المشارطة إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بتحكيم وفقا لجدول زمني محدد بدقة، وحصر مهمة هيئة التحكيم في تثبيت مواقع العلامات الـ 14 المتنازع عليها
وفي 29 سبتمبر 1988 تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، وجاء الحكم في صالح مصر مؤكدا أن طابا مصرية، وفي 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخي برفع علم مصر معلنا السيادة على طابا وإثبات حق مصر في أرضها